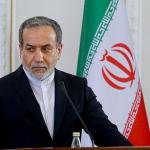أقلام - مصدر الإخبارية
كتب الشاعر عبد الرحيم الشيخ، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، والباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ما خطه زكريا محمد من كلمات عنوانها "المنذر العريان"
في 7 آب 2021 كتب زكريا محمد، وكان صيَّاد أرواح وزارع أفراح، مقالة تصلح للتعريف بالمثقف الذي كانه في علاقته بالحقيقة، عنوانها: “المنذر العريان”. كان مولعاً بتأويل الأحاديث القديمة التي أراد لها أن تنجو من قيود التزمين والتمكين لتصير أداة في مجابهة عسف السلطة، السياسية والاجتماعية والجمالية، وذخيرة في يد دعاة الحرية أنَّى كانوا.
ولذا، فقد نأى عن الثنائية المبتذلة لـ”المثقف والسلطة” مؤثراً عليها ثنائية “المثقف والحقيقة”، إذ الحقيقة، والثقافة ميدانُها الأرحب، كانت في عُرفه “مهمة حربية” ترشدها منظومة أخلاقية رفيعة، وتشكِّلها الدُّربة والملابسة لمنتبهٍ جماعيٍّ عرف فلسطين في مأساتها وملهاتها.
كتبتُ عن شعره في حياته، وقلتُ إنه “ليس كمثله شعر”، وثمة وعد برسم النفاذ للمزيد، الذي عزَّت كتابته، عن السرد. أما فكره، المحمول على رؤية الحياة شعرياً، فلا تصلح له “أعمدة الرأي” التي كان يمقت “التربُّع عليها”، ولا يليق به إلا السجال النبيل والسياق الجزيل.
وأما علاقته بالحقيقة، في الشعر والسرد والبحث، أو ما يمكن أن نطلق عليه “أسلوب زكريا محمد”، فهذا مكانها. فقد غادر زكريا محمد عالمنا في 2 آب 2023، تاركاً وطناً مليئاً بالحقائق والأوهام في حقول السياسة والثقافة، والتي ربما يكون من حسن التدبير التعامل معها بـ”أسلوب زكريا محمد” الذي يوجزه استبطان المثقف شخصيةَ “المنذر العريان”.
في مقالته، التي نشرت على صفحات هذه الجريدة قبل عامين إلا خمسة أيام من رحيله، حاول زكريا محمد تدشين نسابية جمالية لمفهوم “المنذر العريان” في المخيالين الثقافي والديني العربيين. انطلق من بيت الشعر، مجهول القائل: “أنا المنذر العريان ينبذ ثوبه، إذا الصدق لم ينبذ لك الثوب كاذب”.
وبغض النظر عن نسبة الحكمة التي في البيت لشاعر أو لنبي، ونسبة دور البطولة الذي تتحدث عنه مرويات البيت وأسانيده لامرأة أو لابنها، فإنه يشكِّل البوصلة الأخلاقية التي مثَّلها زكريا محمد في حياته، ولا تزال مقولاته العديدة تمثِّلها في غيابه، ومؤدَّاها: أن من لا يمتلك جرأة قول الحقيقة في وجه السلطة، وإنذار قومه بالمخاطر المحدقة بهم حدَّ التعري للفت أنظارهم إليها، فإنه غارق في التواطؤ مع السلطة، وموسوم بالجبن عن مجابهتها، ولا يُعوَّل عليه.
لقد استطاع زكريا محمد، في “أسلوبه”، وبإيماءة لطيفة، أن يحوِّل مركز السجال من “صدق الحقيقة” إلى “صدق حاملها”. فمن الشائع، في اللغات العالمية، التعبير عن صدق الحقيقة عبر وصفها بـ”الحقيقة العارية”، أما “حامل الحقيقة” فلم يقل بعريه إلا العرب الذين التقط زكريا محمد عريهم في لحظة الحسم، ومجَّده.
و”الحقيقة”، وإن كانت عارية، قد تكون موضع جدل وأخذ ورد، لكن أن تبلغ الجرأة في صاحبها حدَّ التعري لإثبات صدقية ما يعتقد أنه الحقيقة، فتلك واحدة من مراتب الفداء. وهذا، بلا شك، يحيل العري على عدة معان: أولها الجرأة والتضحية، وآخرها التخلِّي والاستغناء، وتلك هي “الصوفية الثورية” التي سرق الشعراء الكبار مجازاتها من “منذرٍ عريان” آخر يقال له هادي العلوي، ولاذوا بالفرار من عتابه، ومن وجه السلطة.
لكن “عري الحقيقة” و”عري حامل الحقيقة” لا يضمنان لهما السفور حين يحلُّ الخراب الروحي والفساد السياسي والتثاؤب الثقافي في بلد كفلسطين. فهنا، قال الفدائي الأول لأتباعه قبل ألفي عام: “أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملَّح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يُطرح خارجاً، ويُداس من الناس… أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل”.
ليس المقام هنا محل تنظير للاهوت التحرر الفلسطيني، ولكن هذه محض إشارة إلى معاني “الملح” و”الضوء” بوصفهما أنماط المقاومة الباطنة والظاهرة التي تضمَّنها “أسلوب زكريا محمد” وأسلافه من كبار دعاة الرسولية الثورية، من جبل التطويبات إلى جبل الأربعين.
أقول، ليست كل العيون قادرة على رؤية “الحقيقة” و”حاملها” حتى في أقصى لحظات عريهما النبيل، فـ”بعض العيون مرايا، وبعض العيون غبارُ”، كما أفادنا حسين البرغوثي قبل رحيله إلى صالة المرايا الكبرى قبل قرابة ربع قرن. ولذا، فقد سار زكريا محمد بين خيط الصواب وخيط الخطأ في حقول المرايا والرماد، ليُري الناس الحقيقة العارية التي نذر نفسه لها.
ورغم إعجابه بـ”ذبابة سقراط”، كناية عن المثقف الذي يأخذ على عاتقه مهمة إزعاج السلطة مثلما تعكِّر الذبابة النزقة مزاج حصان أثيني كسول، وقناعته بأنه “في هذا العالم الرهيب، عليك أن [تصرخ وأن] تتقن صرختك، وإلا فإن أحداً لن يهتم بك”، وإعجابه حدَّ التلبُّس بـ”المنذر العريان”… إلا إن “أسلوب زكريا محمد” توزَّع على ثلاث أدوات في محاولة إصلاح الخراب، وبخاصة الكارثة التي تلت عودة منظمة التحرير الفلسطينية، بلا شعبها، إلى فلسطين بعد اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في: الفكر، والسرد، والشعر. لم يصرِّح زكريا محمد بكون هذه الأدوات ركائز “أسلوبه”.
ولكنه أشار، في أكثر من كتاب، إلى ضرورة تدشين حقل معرفي يبدأه بقاموس موجز موضوعه “الأوسلة والدوسلة”، أي دخول الفلسطينيين في كارثة أوسلو (الأوسلة Osloization)، وضرورة تدارك هذه الكارثة عن طريق تفكيكها (الدوسلة DeOsloization). ولو قرأ هواة الرثاء، الرسميين، كتابات زكريا محمد لما وقفوا لحظة إهالة التراب على قبره مذكِّرين الحضور ببلاغة مالك ابن الريب: “يقولون لا تبعد وهم يدفنوني، وأين مكان البعد إلا مكانيا؟”… اللحظة التي تنبأ بها قبل رحيله، والتي غادرنا القسم الأخير من الجنازة لئلا نشهدها.
في الفكر، وفي “ديك المنارة” (2003) على وجه التحديد، أوسط كتب الثلاثية التي أصدرتها “مؤسسة مواطن” قبل أن تصير معهداً في جامعة بيرزيت، أي “قضايا الثقافة الفلسطينية” (2002) و”الراهب الكوري” (2005)، يفتتح زكريا محمد الكتاب بمقالة عن “ديك المنارة” الفعلي، وهو ديك حي وضخم يبدو وكأنه يحرس محلاً لبيع الدجاج المذبوح والمسلوخ قبالة مركز الشرطة الفلسطينية (الذي تحوَّل لاحقاً إلى محكمة، والآن إلى موقف عملاق لسيارات رام الله السعيدة). يتأمل زكريا محمد هذا الديك الذي ارتضى لنفسه “هذه المهنة المرذولة، مهنة أن تكون ديكاً وحارساً لمسلخ في الوقت ذاته! ديك عجوز ضخم لم يعد من المناسب ذبحه وأكل لحمه. لذا، فهو يُترك ليحرس المسلخ.” يواصل زكريا محمد التلغيز اللاذع عن عمليات التهجين التي نفِّذت في حق سلالات شعب من الصيصان والدجاج في قريته (زاوية سلفيت)، وفي زوايا المدينة، وزوايا فلسطين. حينها، كنا طلبة في الجامعة، نتهامس حول مقاصد زكريا محمد، ونطارد نواياه حتى في خاتمة المقالة التي نعتَ نفسه لمحض كتابتها بـ”السخافة وقلة الحياء”، ونتغزل بشجاعته التي كان يمكن أن تودي بحياته وهو أحد أبناء منظمة التحرير الفلسطينية الذي اجترأ على غمز قناة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على هذا النحو بعد أن صار رئيساً للسلطة الفلسطينية. كنا نتكهَّن بهوية الديك المجازي، ونخاف من تكهُّناتنا، ونخاف على زكريا محمد. حينها، لم نكن نعلم أن جرأته ستبلغ وصف الرئيس الفلسطيني الحالي بـ”أبو خميس”، هكذا، دفعة واحدة، دون إضمار ودون حاجة إلى صوص أو ديك أو دجاجة!
أما في السرد، وقد لا تعجب هذه القراءة بعض الاعتذاريين من مثقفي السلطة وقيادتها اليوم، فيمكن الاستدلال بتأويل أكثر جرأة لجانب آخر من “أسلوب زكريا محمد” وبخاصة روايته القيامية “العين المعتمة” (1996)، التي أصدرها له اتحاد الكتاب الفلسطينيين رغم ما يكيله لـ”اتحاد الكتاب” من نقد في شرعيته ونهجه إذا ما قورن بـ”رابطة الصحفيين”.
فالرواية، التي يعجز حتى خيال كافكا عن الإتيان بمثلها من حيث غرائبية كائناتها وميلانكولية سردها وما تضمنه من العجيب القريب والأليف الموحش، تحكي قصة بشير، الأعور ذي العين المضيئة والعين المعتمة، الذي اغتصبته الغولة، وأنجبت منه هجيناً مرعباً… أمضى أهل البلد زمنَ السرد كله في سبيل التطهُّر من رجس الواقعة إلى أن تمكَّنوا من قتل صاحبهم، والتمثيل به، وتقطيعه، وعصر أشلائه، و”محو اسمه وذكره”… باستثناء “عينه المعتمة” التي اختزنت كل هذا الهول، و”عينه المضيئة” التي نجت بالسقوط على أرض مسطبة الجريمة كماسة في حظيرة خنازير، وحدَّقت مفردةً في جموع عيون القتلة. لم نسأل زكريا محمد، في شبابنا، إن كان بشير هو المنظمة التي اغتصبتها دولة المستوطنين الأعداء وأنجبت منها مسخ السلطة، ولم نسأله إن كانت “العين المعتمة” سرده، و”العين المضيئة” شعره، والتأويل فكره… لكننا الآن نسأل، وقد رحل “المنذر العريان” إلى عتمة القبر والذاكرة.
وأما في الشعر، الأكثر مجازاً، فقد كان زكريا محمد أكثر وضوحاً. ففي 22 آب 2021، بعد أسبوعين على نشر مقالة “المنذر العريان”، وبعد قرابة شهرين على تغييب الشهيد نزار بنات، اعتقله أمن السلطة الفلسطينية على مقربة من مخفر “ديك المنارة”. لم يكن زكريا محمد عارياً، فعلاً، لكنه كان “المنذر العريان” لما آل إليه حالُ فلسطين في واقعة انمازت فيها الخراف من الجداء، حين أكلت “الثورة” أحد أبنائها. حينها، كتبت على صفحتي: “الحرية لزكريا محمد. ليس في جيوبه إلا الشعر، والوفاء لفلسطين. وليس لمعتقِليه إلا العار.” وأرفقت بالمقولة قصيدته من ديوان “زراوند” (2020):
“وضعت كل ما في جيوبي
أمام محقق المخابرات العامة:
عملات معدنية، علاقة مفاتيح، منديل ورقي،
علبة علكة صغيرة، فواتير ماء وكهرباء، وأوراق مخربشات،
ثم قدمت اعترافاتي كاملة وخرجت.
ليس عليَّ دَين لأحد، ولا لي دَين عند أحد.
مفتوح على المطلق مثل من فقد أباه وابنه معاً.
وصاعد في طريق العدم مثل نار تصعد جبلاً وتأكل أشجاره…
وضعت كل ما في جيوبي على منضدة الله: هذا كله يا رب. التجربة كلها.
الصح والخطأ. حبة المشمش والطلقة معاً. ورقة براءة ذمة.
أعطني اسماً آخر كي أدبِّر في هذا الكون نفسي.”
حينها، كانت لحظة الإهالة ما قبل الأخيرة على جسد زكريا محمد. لكن الناطق الرسمي لم ينطق اسم زكريا محمد على المنارة ولا على الشاشة، والناطق غير الرسمي أدرك سوء فعلة السلطة فتدخل في الخفاء، ومن ينطق باسمهم زكريا محمد، نطقوا بما أراد: اسمه الأبيض من غير سوء.
أما اليوم، وقد رحل زكريا محمد، دون أن يحسم الجدل بشأن دور البطولة في مروية “المنذر العريان”، بين “الخلصة” و”ابنها”، ودون أن آخذه إلى “الخلصة” الفلسطينية في صحراء النقب المحتلة، كما أراد، فليس لي إلا قول القليل عن أسلوبه، ومكافأة ضريحه ببعض الحجارة من “الخلصة” التي سرق العدو بخورها، وأحالها لميدان تدريب لا تشم فيه إلا رائحة البارود.
اقرأ أيضاً: زكريا محمد المشّاء… بدء القصّة ومنتهاها