عرض لدراسة غسان كنفاني في الأدب الصهيوني
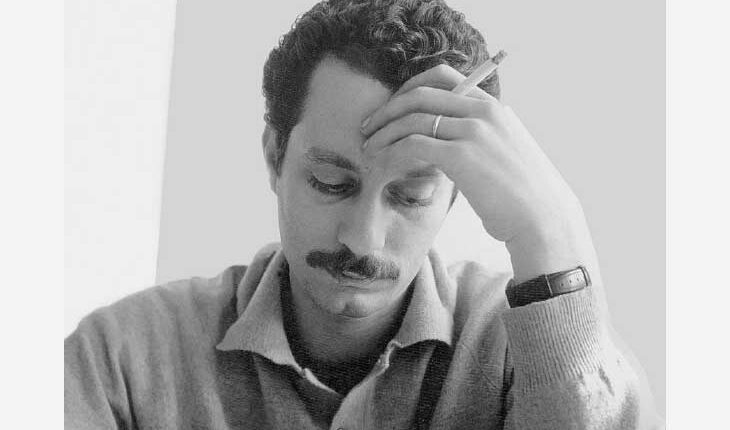
أقلام-مصدر الإخبارية
كتب الدكتور وسام الفقعاوي عرض لخمسة فصول من دراسة الأديب الفلسطيني غسان كنفاني المعنونة: في الأدب الصهيوني، والتي صدرت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1967، وسبقها في عام 1966 صدور دراسته الأولى عام 1966، المعنونة بـ “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966″، وتلاها دراسته الثانية عام 1968، والمعنونة بـ “الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948-1968″، وكأن كنفاني” من خلال دراساته المذكورة – بحسب محسن عتيق خان – أراد تجسيد حكمتين: أولًا “اعرف نفسك”، وثانيًا “اعرف عدوك”.
دراسة غسان (في الأدب الصهيوني) تعتبر رائدة في عنوانها وموضوعها، حيث سلّط الضوء من خلالها، على الدور الذي لعبه “الأدب” اليهودي الموجه في استيلاد الصهيونية السياسية التي تجسدت في مؤتمر بال 1897، لذلك نجده يسجل في مقدمة دراسته بأن الحركة الصهيونية: “قاتلت بسلاح الأدب قتالًا لا يوازيه قتالها بالسلاح السياسي. كان الأدب الصهيوني جزءًا لا يتجزأ ولا غنى عنه، استخدمته الصهيونية السياسية على أوسع نطاق، ليس فقط لخدمة حملاتها الدعائية، بل أيضًا لخدمة حملاتها السياسية والعسكرية، ولن يكون من المبالغة أن نسجل هنا أن الصهيونية الأدبية سبقت الصهيونية السياسية”.
ويذهب غسان كنفاني إلى التأكيد بأن الإرهاصات الأولى للتعصب العرقي اليهودي وتسييس الدين اليهودي، قد عبر عن نفسه في الأدب الصهيوني: “وإذا كانت الصهيونية السياسية هي نتاج للتعصب وللعرقية، فقد كانت الصهيونية الأدبية هي أولى إرهاصات ذلك التعصب وتلك العرقية، وسوف نلاحظ أن التيار التعصبي العرقي، وتسييس الدين اليهودي عبّر عن نفسه أولًا بالأدب، وأن هذا الأدب قام، تحت ضغط نمو العنصرية في القرنين الثامن والتاسع عشر بلعب دور دليل لذلك التيار اليهودي المتعصب الذي ما لبث أن بلور نفسه في حركة صهيونية سياسية”.
اقرأ/ي أيضا: غسان كنفاني.. الذكرى الـ50 على اغتيال صاحب “أدب المقاومة”
وبعكس المتوخى من الأدب في تلازمه مع القيم الإنسانية النبيلة، إلا أن ما سُميَّ بالأدب الصهيوني -حيث كان غسان في أغلب صفحات دراساته، أينما يرد كلمة الأدب الصهيوني يضعها بين مزدوجين- مختلفًا منذ البداية: “وربما كانت تجربة الأدب الصهيوني هي التجربة الأولى من نوعها في التاريخ، حيث يستخدم الفن في جميع أشكاله ومستوياته، للقيام بأكبر وأوسع عملية تضليل وتزوير تتأتى عنها نتائج في منتهى الخطورة. وكان من أولى هذه النتائج أن أدت عمليه من هذا النوع إلى غسل دماغ جماعي في كل ناحية من أنحاء العالم استخدمت في تحقيقها الوسيلة التي ما يزال الإنسان يعتبرها وسيلة تنوير وتوسيع أفق وكشف حقائق”.
الصهيونية تقاتل على جبهة اللغة
يذهب “غسان” إلى أن جبهة اللغة للصهيونية السياسية، كانت بالغة الأهمية، في محاولة منها لخلق رابطة قومية لليهود الموزعين على مختلف دول العالم، ولا توجد رابطة بعينها تجمعهم، وعليه “لقد كان من المصيري، بالنسبة للصهيونية كحركة سياسية مفتعلة، أن تقاتل على جبهة اللغة قتالًا مريرًا يوازي قتالها على صعيد جبهة الاندماج التي كانت بديلًا لها؛ فطوال ألفي سنة تقريبًا كفت اليهودية عن كونها رابطة قومية، وفقدت كل العناصر التي يشكل مجموعها قومية ما: فلم يكن ثمة رابطة جغرافية، ولا حضارية، ولا اقتصادية، ولا ثقافية، ولا سياسية بين يهود العالم، وقبل ذلك كله لم يكن بالطبع أية رابطة عرقية، والسامية نفسها كانت رابطة سلبية، بمعنى أنها كانت رابطة من الخارج، ولم تكن السامية في الحقيقة هي الرابطة، بل كانت “اللاسامية” بصيغتها الخارجية: لم تكن موقف اليهودي من اليهودي، ولكنها كانت موقف غير اليهودي (الأوروبي خصوصًا) من اليهودي. ولذلك كانت جبهة اللغة، بالنسبة للصهيونية، جبهة شديدة الأهمية أُخضعت للغايات الأساسية، وجُعلت بالتدريج وبالتوجيه المتواصل؛ مبررًا – فقد كانت في الحقيقة الخيط الواهي الوحيد الذي يربط بين اليهود في توزعهم على عرض العالم، ولكن حتى هذا الخيط، كان وجهًا من وجوه العلاقة الدينية، وليس من وجوه العلاقة القومية، واعتبرت الصهيونية أن مهامها الأولى جعل العبرية لغة قومية”.
وكانت المبادرة في هذا الأمر لآحاد هعام، أحد رواد الصهيونية، من خلال مقالاته التي قوضت بقايا “دعوة الاندماج” لدى يهود أوروبا الشرقية، عن “آخر يهودي وأول عبري”، هذه الجملة التي صارت إلى جانب بعيد، شعارًا صهيونيًا في الميدان الثقافي، بحسب “غسان”.
ولادة الصهيونية الأدبية
يؤكد غسان كنفاني بأن: “الصهيونية، بمعنى أنها الحركة اليهودية السياسية باتجاه فلسطين، لم تولد في مؤتمر بال في العشرين من آب (أغسطس) 1897، ولكن هذا المؤتمر كان تتويجًا علنيًا لسلسة من الضغوط لعب فيها الأدب الصهيوني دورًا أساسيًا.
وإذا كانت نهاية القرن التاسع عشر هي العلاقة الرسمية لولادة الصهيونية السياسية، فإن الصهيونية الأدبية بدأت قبل ذلك، وكانت في الحقيقة مادة الصهيونية الفكرية التي كتب عنها موشي هس وليو بنسكر وناحوم سوكولوف وآحاد هعام وثيودور هيرتسل وغيرهم”.
يدرج “غسان” هنا، ملاحظة أولية هامة، وهي: “أن ذروة الإنتاج الأدبي الصهيوني جاءت في الفترات التي تحسنت فيها أحوال اليهود نسبيًا، أي الفترات التي أُعطي اليهود فيها حقوق المواطنة في الدول التي يعيشون فيها، والأهم من ذلك أيضًا هو أنه في هذه الفترات بالذات؛ نمت الأفكار التي رسمت قاعدة الصهيونية العريضة. وعلى عكس التصور الشائع يبدو هذا الاعتقاد غريبًا، فثمة بديهية راسخة تقول: إن اضطهاد اليهود هو السبب الذي دفعهم إلى الشعور بالتميز، وبالتالي اكتشاف “أرض الميعاد”؛ اكتشافًا سياسيًا أخذ طابع الشعور بالاكتفاء والخلاص واسترداد الكرامة”.
فيما يؤكد “غسان” من خلال دراسته لتاريخ الإنتاج الأدبي اليهودي، بأن الأكثر رقيًا وتطرفًا – من هذا الإنتاج- قد تحقق في فترات يمكن اعتبارها، بالنسبة لتاريخ التيه اليهودي؛ فترات انفراج.
ويذهب في التأكيد بقوله إلى إنه: من النادر أن نرى إنتاجًا يهوديًا بارزًا وخلاقًا كان وليد فترة الاضطهاد: فقد عاش اليهود الأسبان وسكان فرنسا الجنوبية في فترات الاضطهاد التي أعقبت التراجع العربي عن الأندلس على دراسة إنتاج ابن ميمون[1] وتوسيعه والتعقيب عليه، وتلاحظ الشيء ذاته أيضًا في الفترة الاضطهادية التي أعقبت تفسيرات راشي للتلمود، والتي كتبها في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، والتي بقيت مصدرًا للفترات التي جاءت في أعقاب عصر راشي[2]”.
يُرجع “غسان” في هذا الفصل من الدراسة أساس مسألة رفض الاندماج، رغم فترات الانفراج التي تمتع بها اليهود في العديد من الدول الأوروبية التي أقاموا بها، إلى الرفض القائم على التميز العرقي والعنصرية المحضة: “إن الاضطهاد لم يكن في الحقيقة الموضوعية؛ الرحم الذي استولد الصهيونية، ولكن ما يبدو أقرب إلى الحقيقة هو أن الفترات الانفرادية التي كان يمكن أن تكون مدخلًا إلى الاندماج، كانت تُرفض من قبل طبقة يهودية خاصة؛ رفضًا عرقيًا وعنصريًا محضًا، كان ثمة استبدال في الأدوار، بين المضطهَد والمضطهِد، يلفت النظر فعلًا.. لقد تولى الموقف العرقي اليهودي الذي قاده غالبًا رجال يهود تمتعوا بامتيازات خاصة على حساب الأقلية اليهودية المضطهَدة؛ إفراز الصهيونية الساسية، من مواقع عنصرية”.
العرق والدين في الأدب الصهيوني يستولدان الصهيونية السياسية
إذا كانت فرص الاندماج والذوبان في المجتمعات الأوربية قد بدأت في الاتساع، خاصة في أوائل القرن التاسع عشر، ومع انتشار أفكار؛ الحرية والمساواة والإخاء التي تبنتها الثورة الفرنسية، حيث في عام 1811، بدأت الحركة الإصلاحية اليهودية في ألمانيا؛ متأثرة بتلك الأفكار، وتسعى إلى عصرنة اليهودية: دين وثقافة، إلا أن “غسان” يسجل بأنه رغم: هذا الانفراج ومحاولات العصرنة، نما تيارًا من التعصب في الاتجاه المضاد في الأوساط اليهودية ذات الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، وسيبدأ أدب من طراز صهيوني يبرز بروزًا مستمرًا، ليس في مطلع القرن التاسع عشر أكثر من وميض خاطف وعلامات، ولكنه يتخذ طابعًا أشد وضوحًا في منتصف القرن ليصبح شائعًا في أواخره مفجرًا، في النهاية الصهيونية السياسية التي كرسها مؤتمر بال عام 1897.
ويعتبر “غسان”: أن منتصف القرن التاسع عشر نقطة الانعطاف لعملية التحول التي حدثت: ففي 1858 صار اليهودي ليونيل روتشيلد عضوًا في البرلمان البريطاني عن لندن لأول مرة في تاريخ اليهود، ويعكس وصول روتشليد إلى البرلمان تيارًا من نفوذ يهودي متصاعد، ويتزايد هذا النفوذ باطراد فيصبح يهودي آخر، لأول مرة، رئيسًا لبلدية لندن في عام 1880. وفي هذه الفترة نفسها أيضًا، يعتلي بنيامين دزرائيلي اليهودي كرسي رئاسة الوزارة مرتين، وفي عام 1900 يصل عدد اليهود في بريطانيا إلى ربع مليون يسكن ثلثاهم في لندن، بعد أن كان عددهم في أوائل القرن التاسع عشر لا يتجاوز 8000 يهودي، ولم تكن أوضاعهم الاجتماعية تتميز بصفة خاصة.
ويلحظ بأنه: “مع هذا التغيّر في التركيب الاجتماعي والسياسي لليهود الإنجليز، يحدث بصورة موازية، تغيّر في طليعة الإنتاج الأدبي المتعلق بالقضية اليهودية، ولسوف نشهد في النصف الأخير من القرن التاسع عشر؛ انعطافً نهائيًا نحو تسييس الشخصية اليهودية في الأدب. ولم يكن هدف هذا التسييس، إلا تأكيدًا على رفض الاندماج في المجتمعات التي يعيش فيها اليهود كحل للمشكلة اليهودية”.
يستعرض “غسان” في تأكيد ذلك، رواية بنيامين دزرائيلي “دافيد آلروي” التي كتبها عام 1833، ويذكر أهمية تناوله لها لسببين؛ أولهما لذاتها، وثانيهما للنتيجة التي أدت إليها. ففي هذه الرواية يطرح كاتبها البطل اليهودي الصهيوني، قبل حوالي نصف قرن من ولادة الصهيونية رسميًا في بال، حيث: يرفض الاندماج وكل فرصه، ولذلك يسقط فورًا في الموقف العرقي المتطرف الذي سيتبناه هتلر مقلوبًا بعد 80 سنة!
لقد حمل – دزرائيلي- قضية التميز اليهودي التي اعتبرها سيمغوند فرويد “قوة للبقاء”، نحو نهايتها الحتمية؛ فجعلها قوة للغزو، فكي ترفض الاندماج ينبغي أن تتبنى واحدًا من موقفين: أولهما؛ الشعور بالضعة، وثانيهما؛ الشعور بالتفوق، ولم يكن أمام دزرائيلي، وقد رفض الاندماج، إلا أن يسقط في فخ العنصرية.
ويؤكد “غسان”: إن تفوق وتميز البطل اليهودي في رواية “دافيد آلروي” هو تفوق وتميز عرقي ليس إلا، ذلك أن دزرائيلي يمسح العالم كله بهذه المسطرة الهتلرية الكريهة: “إن كل شيء عرق… ليس ثمة حقيقة أخرى”. ويصر دزرائيلي على أنه حتى “ما يعتقده الناس سلوكًا فرديًا، ما هو في الحقيقة، إلا شخصية العرق”، وعليه يؤكد طوال صفحات روايته: “إن العبريين عرق غير مختلط”، أي عرق نقي!
الأدب الصهيوني يضبط خطواته مع السياسة
يكشف “غسان” في هذا الفصل من دراسته، عن السمة الدعائية الموجهة “للأدب الصهيوني”، لتحقيق أهداف سياسية قائمة على قلب وطمس الحقائق والتزوير وتشويه المعطيات التاريخية والكذب والاستخدام الانتهازي، غير ذي العلاقة لأحداث الماضي في تبرير أحداث جديدة، بعيدة زمانًا ومكانًا وفكرًا وبشرًا عن بعضها، حيث يذهب “غسان” إلى أن: هذه المهمة المتناقضة للأدب الصهيوني كانت مهيأة بالطبيعة للسقوط في أخطاء مهلكة؛ شكلًا ومضمونًا، ومع ذلك فقد استطاعت الآلة الصهيونية الجبارة أن تمنع حدوث أي فضح ذي شأن لذلك النوع اللاأخلاقي من غسل الدماغ عبر العمل الفني. لذلك فكانت الدعائية هي سمة هذا الأدب الذي جعلته يختلف جوهريًا عما صار يعرف بأنه الأدب الموجه؛ ذلك أن الأول –على عكس الأخير- يعتمد في الأساس على إخضاع الحقائق بأي ثمن لخدمة موقف مسبق، حتى لو كان هذا الإخضاع يستلزم تشويه المعطيات التاريخية، والكذب حينًا، والتجاهل أحيانًا، والفرار من النتائج التي تطرحها تحليلات وافتراضات مقحمة بالقوة في العمل الفني… والذي لا شك فيه، أن ثيودور هرتزل أول من أعلن هذا الاتجاه بصراحة في مطلع القرن العشرين، حين نُشرت روايته “الأرض الجديدة القديم”، هذه الرواية التي استبقت عند هرتزل نفسه، الصهيونية السياسية، وكانت حافزًا لقلب هيرتزل “الفنان” إلى هرتزل “السياسي”.
العصمة اليهودية أمام “عدم جدارة” الشعوب الأخرى
يُعلمنا “غسان كنفاني” بأن الكاتب الصهيوني روبن وولنرود يفسر عصمة البطل اليهودي وتفوقه المطلق بقول الأخير: “إن الكاتب اليهودي يفقد كثيرًا من موضوعيته بسبب شعوره الكامل بهويته وبمسؤولياتها…، ولذلك، فإن القرب الشديد من الأحداث والشخصيات تعطي كتاباته حيوية، ولكنها تعطيها، في الوقت نفسه، نوعًا من المايوبيا[3]”.
فيما يؤكد “غسان كنفاني” تعليقًا على ما سبق، بأننا “سنرى في الواقع، أن العكس هو الصحيح: فإذا كان الكاتب اليهودي قريبًا حقًا من الأحداث، بالمعنى العقلي والجسدي أيضًا، فإنه يفقد موضوعيته بالقدر الذي يفقدها كاتب صهيوني يتناول الأحداث من بعيد. ولذلك فإننا سنلحظ دومًا بعدًا عن الموضوعية كلما ابتعد الكاتب عن الأحداث، وبعدًا أقل كلما اقترب منها… إن الرواية الصهيونية لا تضخم الحقائق وتنفخها بالمبالغة، ولكنها تخترعها أيضًا… حيث أبرزت العديد من الروايات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، روايتي “لصوص في الليل” لآرثر كوستلر، و “طوبى للخائفين” ليائيل دايان؛ الشعور العميق بالتفوق العنصري المطلق، وهذا التبجح بالتفوق المطلق إلى جانب العصمة الغيبية، أدى إلى موقف عرقي واضح من الشعوب الأخرى وخصوصًا العرب”.
ويرى “غسان كنفاني: بأن: الحركة الصهيونية لم تكن قادرة على تبرير غزوها لفلسطين، إلا بالمبررات التي اعتمدها كل غزو في التاريخ، وهو التفوق البدني والحضاري والذهني والأخلاقي، ولكن هذه الدعاوى لها وجهها الآخر الملتصق بها، وهو الطريقة التي ينظر فيها الغازي إلى الشعب الذي يتعرض للغزو، إلا أن الحركة الصهيونية، في الرواية كانت مطالبة بتغطية قضيتين في آن واحد، داخل هذا النطاق؛ الأولى تبريرها لرفض اندماج اليهود في المجتمعات التي عاشوا فيها في الخارج، والثانية تبرير اقتلاع شعب كامل من أرضه.
المبررات الصهيونية أمام اغتصاب فلسطين
يفتتح “غسان” هذا الفصل من دراسته، بقول المؤرخ البريطاني أرنولد تونبي: “أستطيع أن أفهم مطالب اليهود بعد كل الذي عانوه على أيدي الألمان، بأنها مطالب ترمى إلى إعطائهم ولاية في مكان ما من العالم ليمارسوا سيادتهم الخاصة فيه، وإذا كان لا بد من حدوث ذلك، فتلك الولاية ينبغي أن تكون على حساب الغرب الذي ارتكب أقصى الفظائع مع اليهود، وليس على حساب العرب. إن هذه النقطة تبدو لي سهلة وسليمة، ولكن حين أشرت إليها مرة في بلد غربي، وهو ليس ألمانيا ولا إنجلترا؛ قوبلت بموجة من الصياح الضاحك”.
يعلق غسان على ذلك، بالقول: “يبدو أن الدعاية الصهيونية رسخت في الذهن موقفًا بعيدًا للغاية عن هذه العملية الحسابية الإنسانية البسيطة التي وضعها تونبي، بتلك السهولة والتقريب، وينعكس هذا الترسيخ، بصورة أخص على الرواية الصهيونية”.
ويؤكد غسان كنفاني بأن: أحد المبررات الصهيونية لغزو فلسطين يعتمد في جوهره على “الرد على المذابح الهتلرية ضد اليهود خصوصاً، وعلى الاضطهاد الذي تعرض له اليهود عمومًا”، ولذلك فإنه من المستحيل تقريبًا أن يجد المرء رواية صهيونية عن فلسطين لا يكون المدخل إليها مبنيًا عبر المذابح الهتلرية، ويبدو أن المؤلف الصهيوني يعي قيمة هذا السيف الدموي الذي يسلطه منذ البدء على ذهن القارئ الغربي، فيضمن، من الصفحات الأولى كسبه إلى جانبه، مهما ارتكب من أخطاء.
سؤال “غسان كنفاني” الذي طرحه في نقاش ذلك الأمر، في سياق تفاعله مع قول “تونبي” السابق: ما شأن عرب فلسطين بدفع ثمن مذابح ارتكبها الغرب ضد اليهود، خصوصًا وأن اليهود عاشوا في المجتمع العربي على مر العصور في انفراج مستمر تقريبًا؟
وفي محاولة الإجابة يؤكد جازمًا: بأن هذا السؤال على بداهته، يظل بعيدًا عن اللمس، وكل المحاولات التي تبذلها الرواية الصهيونية للإجابة عنه من بعيد؛ تسقط في تناقض مهلك، وأحيانًا مضحك.
[1]. أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله القرطبي، شخصية دينية وفكرية يهودية في أوساط يهود المشرق العربي والأندلس، خلال العصر الوسيط.
[2]. هو اختصار لاسم الحاخام الإشكنازي “رابي شلومو بن يتسحاق”، وكان رئيس إحدى المدارس التلمودية، ويعتبر من أشهر المعلقين والمفسرين للتلمود في عصره.
[3]. تعني: قصر أو حسر النظر



